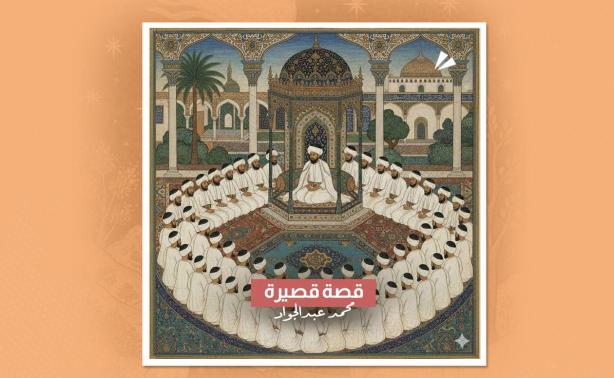بدأ كل شيء، كما يذكر ابن كثير، عندما كان الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم الشريف، والذي ينتهي نسبه إلى أحد أئمة آل البيت من الفرع الكاظمي تقريبًا، يحضر حلقة علم عادية بأحد مساجد البصرة في زمن الخليفة الواثق بالله، وقد سمع الشيخ يردد بصورة طبيعية من سورة مريم:
«فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا (26)»
كما يذكر ابن كثير، أثرت الآية في السيد محمد بن عبد الكريم الشريف، وقرر حينها أن يبدأ دعوته الغريبة التي لم تستمر سوى خمسة أعوام.
بذرة الفكرة: وحي الصمت بعد سماع الآية
الإشارة إليه هنا كانت مقتضبة، فلم يشرح ابن كثير ما يكفي عنها كأنه كان ينأى بنفسه عن الخوض في حق رجلٍ من الأشراف وعالمٍ رباني معروفٍ في زمنه، ولكنها وردت بصورةٍ أكثر تفصيلاً مع بحث رائد تقدم به فرانسوا البيك، وهو أستاذ جامعي كندي من أصول شامية بعيدة، يدرس التاريخ الوسيط الإسلامي تحديدًا، وانشغل فترة بتجلٍّ من تجليات الحضارة والذي تجسد في الحركات الدينية التي كانت تنشأ في الزمن العباسي المديد، تنشأ صباحًا أحيانًا وتنتهي مساءً.
وكان ذلك وجهًا آخر لعملة النجاح الحضاري؛ فرغم تردي أوضاع الدولة العباسية في سبعين بالمائة من مجمل تاريخها تقريبًا، هناك رواجٌ في الحركات الدينية والحركة الأدبية بل والثورات المختلفة ـ ذكر أول ثورةٍ قوية قامت بها قوى العمل الأفريقية أو الزنج وقتها والتي تماست مع حركة القرامطة الخطيرة، والتي يلزم الحديث عنها وقتًا لأنها قرنت بموضوع سرقة الحجر الأسود والذي لم يكن فعلاً ينم عن الكفر كما قيل، بل مبادرة جريئة لانتزاع مجسم مادي كان يعبد من دون الله على حد قول فقهائها ـ وهو ما يشبه ما تمر به الحضارة الأوروبية الشائخة حاليًا، وحتى منذ بدايات عصر النهضة، حيث تعددت الحركات الدينية والإنسانية في العموم، بما يحدث أيضًا للحضارة الأمريكية، مع كل التجليات الحديثة مثل حركة الحفاظ على البيئة أو ضد البلاستيك أو النسوية والنباتية والمثلية إلخ إلخ، وكتب فرانسواز البيك:
«كل حضارةٍ يتسع صدرها لمذاهب مختلفة دينية وغيرها تضمن بقاءها، على عكس المعتقد بأن مناهضة كل الحركات المختلفة يحفظ الدين والحضارة والناس. في النهاية، استمر الإسلام بصيغته نفسها طوال قرون رغم آلاف الحركات».
المهم أن البحث الذي تقدم به فرانسوا البيك كان يخص الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم الشريف ذلك، وكان يخص ما يمكن أن نسميه على أيامنا؛ تقليعة شديدة الغرابة، وهي كلمة تنقص من القدر الكبير للرجل، فالدعوة الغريبة التي قادها بصلابة وعزم، كانت تخص أول وآخر دعوة تاريخية تقريبًا يكون الصمت محورها. في كتاب نادر، وجده فرانسوا البيك ضمن شبكة معقدة بدأت ببيعه عن طريق بائع تحف تركي عتيق، ثم وصل لرجل متخصص في جمع النوادر، وهو: «الثبت في فضل الصمت»، وقد كتبه رجل اسمه عباس بن عبد الكريم الملقب بابن زلفى، يعتقد أن قرابة بالدم تجمعه بالفقيه السيد محمد بن عبد الكريم، بسبب تشابه الأسماء والمعلومات التي صاغها؛ في هذا الكتاب تحديدًا وردت تفاصيل شديدة الإثارة عن الدعوة.
في لحظة بعينها بعد الاستماع للآية، شعر الفقيه بن عبد الكريم بأنه لم يعد يسمع شيئًا، ذكر ذلك بالتفصيل لكاتب الكتاب بقوله: للوهلة الأولى تجسدت الخواطر كلها لتصير خاطرة كبيرة عن الصمت الذي يلف المقابر والذي يختلف عن صمت جمع يجلسون في مكان ما كأن على رؤوسهم الطير، فصمت المقابر جسيم، له مكانة خاصة ووزن، ولعل صمت مريم عليها السلام حولها إلى ما يشبه جسد ميت في حب الله. ثم صارت الخاطرة الصغيرة تلك بحرًا بعدها، فقد اكتشف أن الصمت يلف كل المخلوقات القديمة في العالم، ما عدا الحيوانات، فالأشجار صامتة، ما عدا هسيسها وقت الرياح، والنباتات بلا صوت، بل يُخلق لها الصوت خلقًا عندما يقطعها الإنسان كأنها صرخة انتفاض، كما أن الجبال العتيقة والبيوت وكل ما يصنعه الإنسان تقريبًا بلا صوت، وفي أوضاع كثيرة، تسكت حيوانات النهار في الليل لتترك فسحة لحيواناته، بينما تسكت حيوانات الليل نهارًا.
هكذا بدأ يتحدث عن الصمت وأطروحته حوله من منظور فلسفي يتماس مع الدين بشكل خفيف، مفسرًا بالأساس لصمت السيدة مريم العذراء باعتباره أبلغ رد على الجميع، وباعتبار أن الجميع هؤلاء من الإنس تحديدًا ـ اختص الإنسي بالصمت ـ وهي ملحوظة وصلت به إلى أن الإنسان نفسه والذي اشتق اسمه من الأنس تحديدًا كاجتماعي يبحث عن الآخرين ويحيا بهم، يظل إنسانًا أي في مرتبة أدنى من تحوله إلى إنسان علوي، أي يصمت ويسمع كلام الله في الكون وكلام الملائكة، بينما ينزل ما تحت الإنساني عندما يصرخ ويصيح ويصير مثل الحمار بأبغض الأصوات: كأنه حيوان سفلي يصرخ هنا وهناك، رغم أن الحيوانات نفسها محكومة بقانون الصمت.